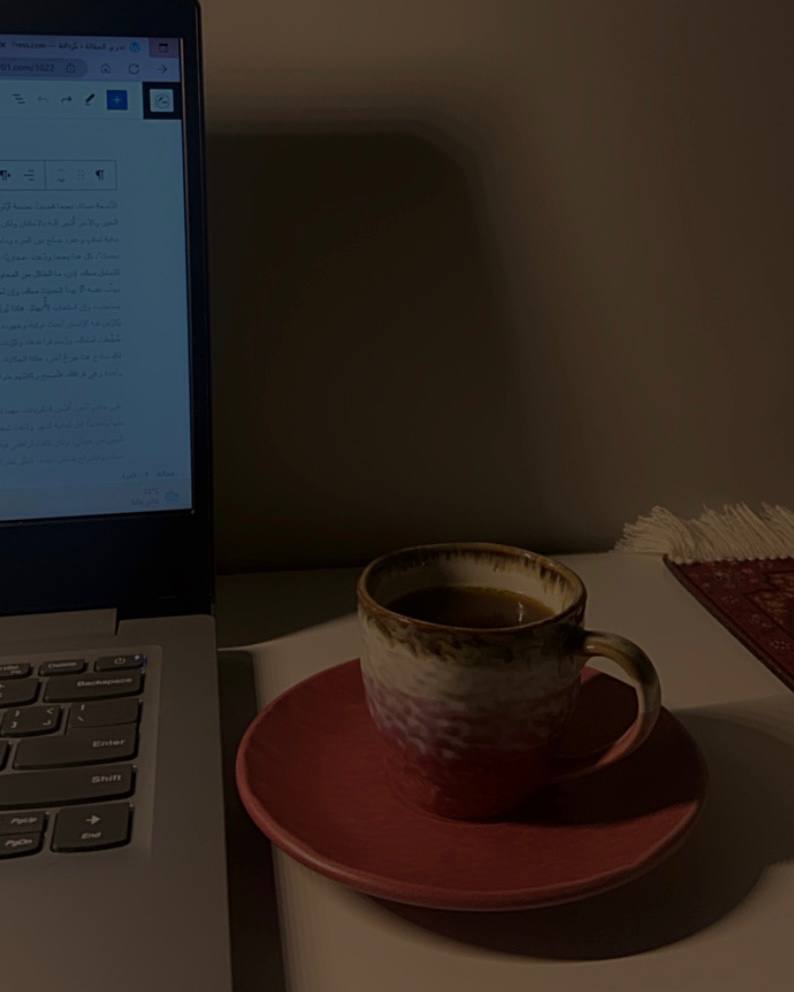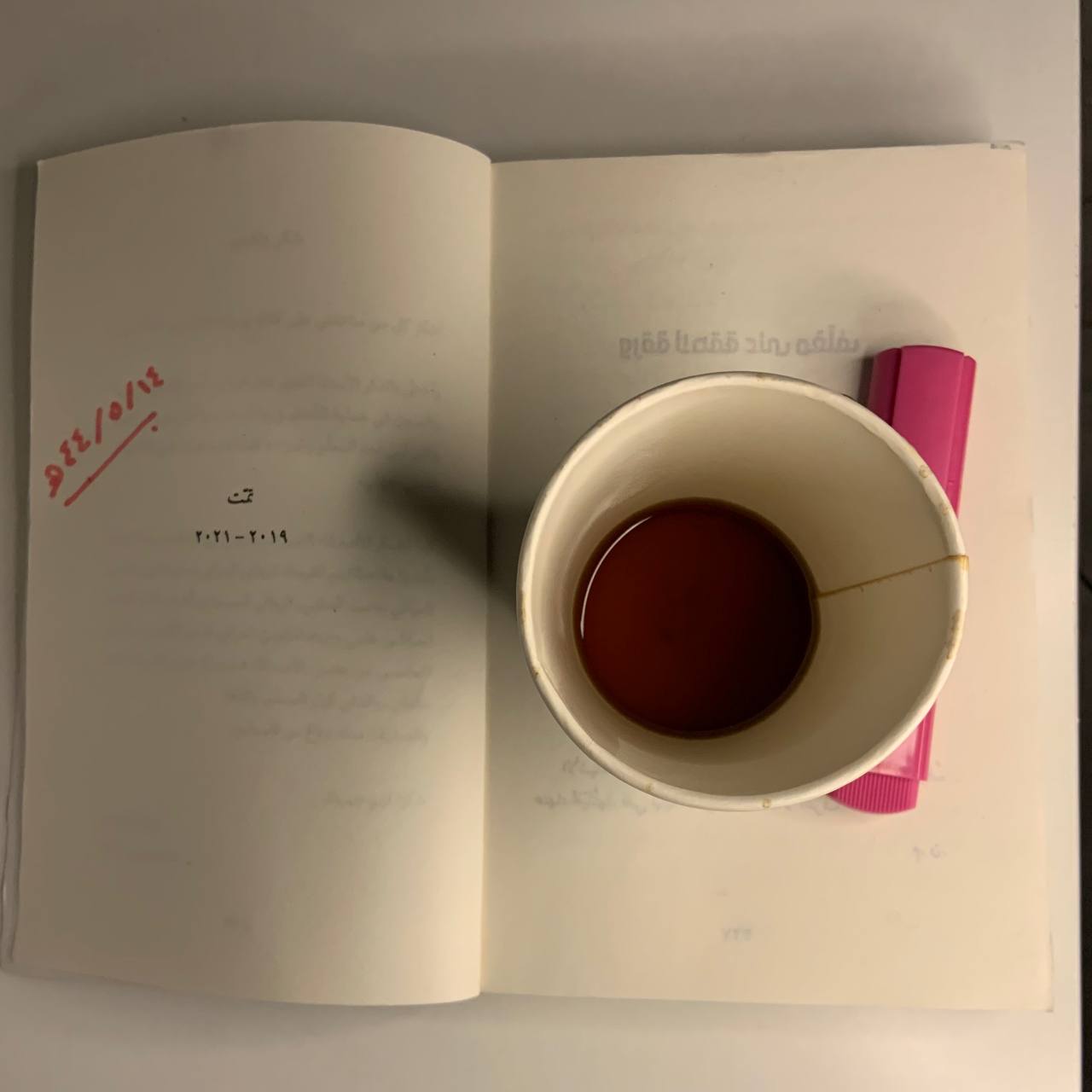الخامسة مساءً، أتحفّز لكتابة هذه التدوينة ولا أعلم متى سأنشرها، ما أعرفه أنّها ستكون مزيج فوضوي جدًا من عدّة أيامٍ مضت ومشاعر. والخلفيّة الصوتيّة المُرافقة: “بكيت من العطش وأنا في غديرك.. شربت من الظمأ دمعات عيني”. بعد هذا الانقطاع الطويل عن النشر في أكثر من منصّة اجتماعية، وعن المدونة، وتوقّف استلام أعمال المحتوى لأكثر من شهرين، إجراءات كانت بالسّابق عصيّة على التنفيذ، ولكن كنتُ حازمة وأخيرًا بشأنها لهدف التركيز على الدراسة، وتجلّى لي أنّها من أفضل قرارات السّنة، أحملُ منها الكثير من المباهج وأودّ مشاركتها كلها، وفي رأسي الكثير من الأمور التي ادّخرتها للكتابة، لكن المعضلة المستمرة: ما هو التمهيد المناسب؟
عندما أشعرْ بالضيق وتتكدَّس الضغوط حولي، أسير عكس التيار، أتوقف عن ممارسة الأنشطة المُفضَّلة، أكره التفاعل مع المحيط الاجتماعي، لا أتحدث مع أحد وأكره أن يحادثني أحد، أتحوَّل لكل شيءٍ قابلٍ للاشتعال، انغمس في الضغط للحد الذي يجعلك تظن أنني أُرحِّبُ به، ولكن الواقع أنّ تلك طريقتي لمعالجته، آخذه معي لمساحةٍ فارغة، أو اصنع له من الازدحام فراغ، وندخل سويًا كهفَ الدَّواء، لذلك تكثر المشاكل والخصام مع من حولي في هذه الفترات، ولا أُحمِّلهم من الخطأ مقدارا. بل بدأتُ أفهم تقلّبات الإنسان الذي يبقى مرهونًا لتشكيل الظروف والضغوط حتّى يخرج منها سالمًا، الأمر متشعّب ومعقّد وله فلسفته الخاصّة، ويستحق عناء الخوض فيه لنفهم بعضنا بشكلٍ صحيح، لكن مع من؟
(2)
في رمضان، قطعتْ مسافة ست ساعات بالسيّارة إلى مدينةٍ ما، أردت بحرها فقط، كانت إجازة قصيرة مُباغتة لم يُخطّط لها وبمثابة إعادة تأهيل للخاطر، من الإفطار، حتّى الإمساك، الغروب والشروق والبحر، تأمّلت أكثر المشاهد التي أُحبّها مباشرةً، بلا أي حواجز، ورغم ما مضى، عاطفيًا لا زلتُ هناك! حيث السجّادة البيضاء الرّقيقة، والحقيبة التي تضمّ كل الاحتياجات، كانَ كابوسي أن اضطر لشيءٍ ما فلا أجدهُ فيها وأتركْ البحر لأذهب وأجلب ما أحتاج من الفندق، لذلك كانت الحقيبة بحجم حقيبةِ السّفر. خلالها لم أفرّط بالعمل على ملف المشروع، كنتُ أُواجه النافذة المُطلَّة على البحر، وأكتب، أكتب الكثير من الهوامش والمراجع والتفسيرات، وفلترة الكثير من الملفَّات، الأمور التي لم أكن سأقوم بها بهذه الدقِّة لولا توفيق الله ثمّ هذه الإطلالة، مُتأكِّدة من ذلك. ولا زلت أُحاول أخذ الإذن لنشر البحث للعامة.
عُدتْ لمنزلي ولمكتبي، وللمسؤوليات التي لا مفرّ منها، وازدادت السّاعات التي يسرقها منّي مشروع التخرج، وافتُعِلَ بيني وبين إحداهن من فريق العمل سوء تفاهم يتعلق بحقوق التوثيق، شعرتْ أنّ الحل في انفصالي عن الفريق، لم تكن المبادئ المُطبّقة تمثلني، لولا محادثاتي مع العزيز تركي، بالمُناسبة، أشعر بالامتنان له لوقوفه الصّادق ودعمه المستمر لي، عمومًا لم انفصلْ، ورغم أن الأمور سارت كما ينبغي، لم تتغيّر نظرتي للعمل الجماعي، فلستُ من الصنف الذي يُفضِّل العمل ضمن فريق، وأرجو أن يحترم العالم أن هناكَ فردًا كجزء منه لا يُجيد العمل بهذه الطريقة الفوضوية، هُناكَ من يكون جودة عملهم المُستقل بجودة عمل فريق، وأكثر، لماذا هذا الإصرار في فرض وتطبيع هذا النوع من الجماعة؟ دعونا نتنفَّس ونُفكِّر ونُبعثر ونُنجز بطريقتنا. وبرأيي أن هذا لا يُنافي التنوّع بالأفكار وتوفير الجهد وما إلى ذلك من التبريرات، لم تقنعني.
(3)
حزينةٌ اليوم، أرغمني هاتفي على محوِ كثيرٍ من الصّور لتحرير التخزين، كنتُ أنتظر رسالة مهمّة جدًا، ما إن وصلتْ اقترن بها تنبيه التحرير، وإلَّا لن أستطيع فتح الرسالةِ وإكمال قراءة محتواها، مرّات كثيرة وجدتُ نفسي تحت سيطرة اختيارٍ سريع، كان هذا الأسوء بينهم، عندها كنتُ في الخارج ولم يكن معي إلا هذا الهاتف، لذا كان خيار نقل الصّور للحاسوب أو لجهازٍ آخر غير متوفّر، أو حتى رفعها سريعًا لسحابة تخزين، ولحاجتي لمحتوى الرسالة حذفت نصفها إرضاءً للسيد الهاتف. الموقف جعلني أفكّر مليًا بشأن طباعة الصور والذكريات التي أحتاجها، أو نقلها لأداة تخزينٍ خارجية، لا أعرف، ولكن هذه الأجهزة ليست جديرة بالثقةِ أبدًا.
علاقتي مع الطبخ متزعزعة ومرهونة بالحالة المزاجية، في الأيّام السّعيدة أُعد ما لذ وطاب، وتمتلئ السّفرة، وإلّا من ستعدّ البيتزا والفطائر في الساعة الثالثة فجرًا إن لم تكن سعيدة؟ كما أنّه يعجبني عندما يُلاحظ من سيشاركني الأكل ذلك من محتويات سفرة الطعام، فيرمقني بنظرة ضاحكة: أنتِ سعيدة اليوم!
في فترة انقطاعي عن الحياة الالكترونية، ثبتَ برنامج Snapchat فكان خاتمة كل ليلة أذهب فيها إلى السّرير وأُقلِّب المقالات، أُتابع المُبتعثة رزان في أتلانتا، أحب الطريقة التي تُفكِّر فيها، عن جمالية المشاهد التي تُلهمها، أحب حقيقتها وإنسانيّتها التي لم تتأثر بشيء من الابتعاث، والمنصات الاجتماعية، وأنّها بعيدة عن الشد والجذب البائس، وعن جودة نقاشاتها، أعرفْ أن ما يظهر لا يعكس حقيقة من خلفه تمامًا، ولكن أرى صدق إنسانيّتها المتجلية من خلف الشاشة. نعم.. لقد اكتسبت عادة سيئة يا أصدقاء، انضممتُ للجماعة التي لا تهنأ بلقمة أو تنعس ليلًا دون أن يكون هناك مقطعًا مرئيًا تتابعه أو خبرًا تُحلّله، هذا نتاج قهقهاتي وشماتتي!
(4)
الخميس، الرابعة فجرًا، استعد لآخر امتحانٍ في السّنة الطويلة هذه، أعتقد أن عقلي قد اعتاد على السهر في فترات الاختبارات، حتّى لو كنت أموت من النّعاس كما هي حالتي الآن أُناضل لأبقى مستيقظة، في الحقيقة أنها رهبة تولَّدت بعدما فاتني اختبار في المرحلة المتوسطة بسبب النوم، بات هذا كابوسي، لذا لن أنام، لن أستلقي، لن أضع رأسي على المكتب.. بل سأخرج لمكانٍ ما إلى أن يحين وقت الاختبار.. بعد خمس ساعات، يا إلهي! من حسن الحظ أن هناكَ أماكن تفتح أبوابها في السّادسة صباحًا، لذا الأماكن التي سأهرب إليها من النّعاس متعددة، هيا.. ها أنا ذا وصلتُ إلى مقهى أضفته مؤخرًا لقائمة الأماكن التي استلطف الأجواء داخلها، لا أحب الزحام، أيضًا لا أُحب ذاك الهدوء الذي استمعُ فيه بوضوحٍ تام إلى أفكاري، خاصةً الآن، ليس الوقت المناسب ليشرد ذهني عن معالجة الفروقات في العملة الأجنبية -هذا موضوع الاختبار العملي-، وبالطبع فأنا فاشلة في السيطرة على تركيزي لمكانٍ واحد أو لموضوعٍ محدّد، لذلك كان الاختيار لهذا المقهى جيد جدًا. ذهبتُ إلى الجامعة في العاشرةِ صباحًا، تبقّى نصف ساعة، قضيتها في التأمّل بالمارة، وداخل رأسي تموج المعلومات التي حفظتها وفهمتها، وصوتًا سيئًا ظل يُراجع عليّ كل معلومة ويُشكّك في استعدادي، كمّ أكرهه! انتهيتْ من الاختبار تزامنًا مع أذان صلاة الظهر، مبتهجة بالورقة التي لم أترك فيها مساحة بيضاء، وفي طريق العودة شعرتْ أنَّ كل شيءٍ في المدينة قد تغيّر، الحقيقة أن نظرتي تغيّرت، هذه الإجازة، مرحى! نمتُ إلى فجر يوم الجمعة، لا أُبالغ، فأنا مُتعبة، عقلي مُتعب، ومن هنا عادت الأمور إلى سيرها الطبيعي، النوم في الليل، تناول الوجبات المنظّمة، الحالة المزاجية مستقرّة جدًا، الدنيا تعود لألوانها الزاهية، الكتب تحتل مكانها في المكتبة الصّغيرة، القهوة تغرق بالزعفران، الأريكة المهجورة صارت مكاني المُفضَّل لاحتساء القهوة، والقراءة، عقلي يُفكّر بطريقةٍ أخرى.
(5)
صباح السّبت، أول قرارٍ قفز إلى عقلي جرد الملابس وتنظيف أدراج المكتب من الفائض، وتنظيم أدوات التجميل، الجرد الدوري للخزائن والأشياء عادة اكتسبتها من والدتي حفظها الله، كانت بين الحين والآخر تأمرنا بجلب كل شيءٍ لا نحتاجه لدينا، فتملأ الصناديق بالجيّد منها لتتبرع به، والتخفّف من اللاجدوى من اكتنازه، كنتُ أفعل ذلك منذ سنتين، وأُخصِّص العطلة الصيفية للجرد العميق والتخفيف، بالطبع اليوم لم أُطبّق ذلك على كل المنزل ومحتوياته، كان تركيزي فقط على غرفتي الخاصّة، في محاولةٍ لإعادة ضبط التوازن والاستقرار النفسي للمكان الذي أُحب وأقضي فيه معظم أوقاتي.
تحدّثت حديثًا عميقًا مع أحدهم العزيز، منذ فترة طويلة لم أتجاذب أطراف الحديث طويلًا وبهذا الشكل في شتى الجوانب، اقترحَ علي فكرة عمل، وفي الأثناء قال لي: (فكّري، متأكد بأنّكِ ستُخرجينه بأفضل طريقة إن رغبتِ)، فرحت لهذه الجملة، وأخيرًا بات من حولي يفهم أنّ الرغبة بالشيء هي التي تحرّكني، فعندما لا أرغب.. لن أعمل! ولكنْ لأجله فقط بدأت أعطي فكرته الاهتمام، هل سأُضيف على كاهلي مسؤولية جديدة بجانب الدراسة والعمل الحر، لا أعلم!
إلى هُنا، النّعاس يطرق بابي.. ألقاكم بخير.