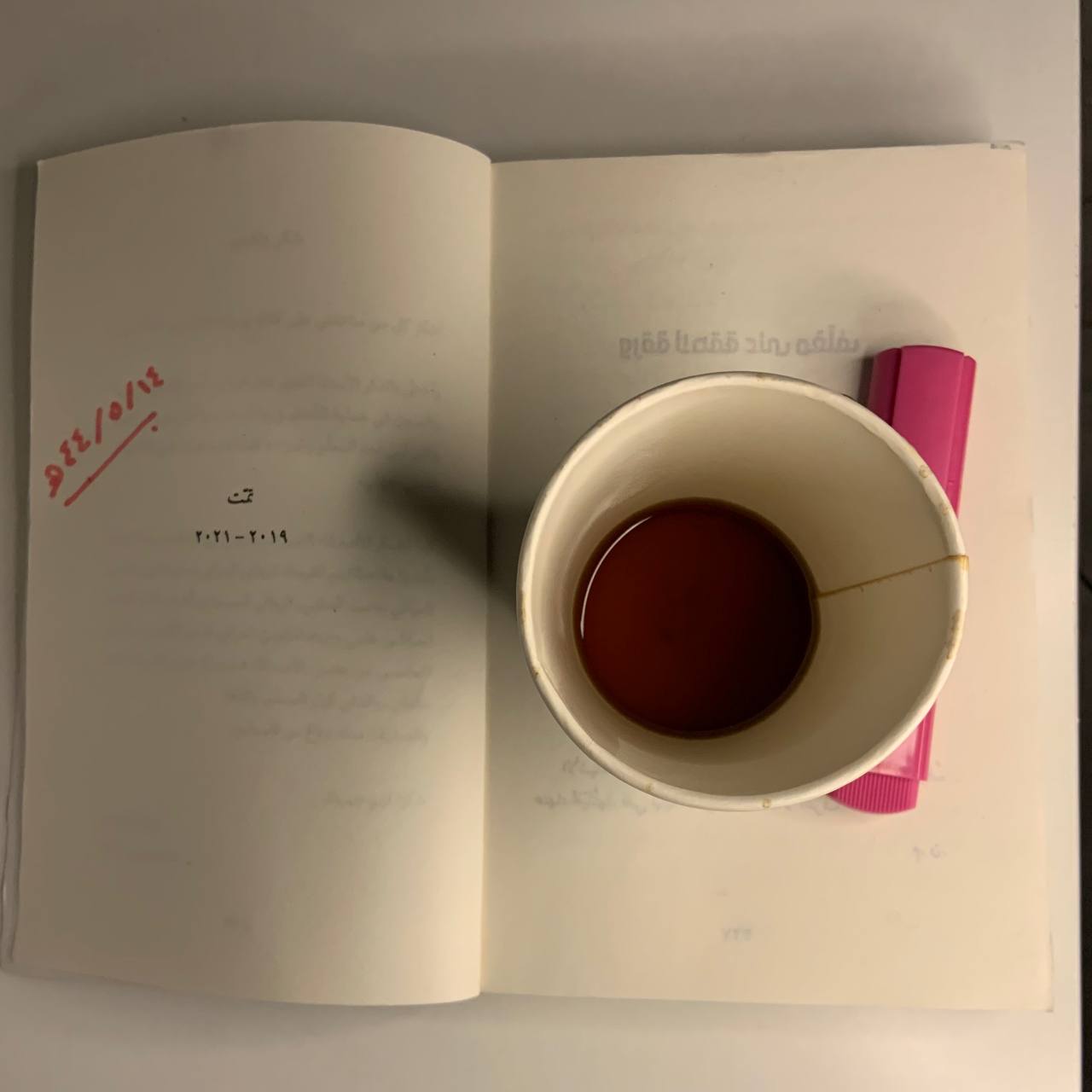لم تخرج نتيجة اختبار الفحص سريعًا، وددتُ أن يكون هناك خطأ ما، ليس لأنني أخشى الجائحة، إنّما لأنني قبل الاختبار بيومٍ واحدٍ فقط خرجت للتنزّه خارج المنزل، اختلطتُ بالكثير، وتعاملت مع كثيرٍ من البائعين، وشربت قهوتي المُفضَّلة في المقهى الذي أُحبّه، ابتسمت لجميع من اصطدم بكتفي، وكتبتُ على منديلٍ أثناء الانتظار، ولم آخذه معي، تركته على الطاولة. لم يُراودني شك أنني أحمل الوباء، لا أشتكِ من أيّ أعراض، بخلاف الصداع الذي لازمني خلال الأسبوع، وبالنسبة لفتاة تقضي معظم أوقات يومها بين شاشة الحاسوب والأوراق والدفاتر، لم آخذه على أنه عرض جدّي للوباء، وهذا والله الذي أنا آسفة عليه، وربّما تكون هذه النقطة الوحيدة التي تُحزنني من كل الأمر، وعندما خرجت النتيجة إيجابية وثبتت إصابتي بوباء كورونا، حزنت لأجلهم أكثر وتمنيت ألّا يكون هُناك من تأذّى! وشاركت من استطعت الوصول إليه نتيجة الاختبار لتبرئة الذمّة.
(1)
الجُمعة، السّاعة الآن الواحدة بعد منتصف الليل، بدأت أول ليالي العزل.. ليلة باردة ضيفيها الصّداع الحاد وآلام الصّدر، لطالما أهديت نفسي ليال وساعات وحيدة أقضيها بينَ هواياتي المُفضّلة، ولكنني تثاقلت هذه الليلة لأنني أقضيها وما بعدها وحيدة مُجبرةً على ذلك، وأعتقد أنّ القوّة في الإنسان تظهر عندما يُجبر على الاعتناء بنفسه وبطعامه وشربه وكل ما يتعلّق به في حال التعب والإرهاق، وفي هذه الليلة تمنّيت أن أكون بجوار والدتي، التي تصنع ألذ حساء دافئ في العالم، وكأس ليمونٍ طازج، وتنهيه بأطرافٍ تمسح برفق على رأسي المُتعَب، أعتقد أيضًا أن قيمة العائلة والأصدقاء والأحباب وزملاء السّكن تظهر عندما يمرض الإنسان، وفي قلبي أؤمن أنه لا يُمكن أن يغتني الإنسان عن الآخرين والاكتفاء بالله وحده بلا شك، لكنّ ربما تستطيع أن تحتوي حزنك وحيدًا، ومرضك وحيدًا، وفرحك وحيدًا، لربما تفعل كل شيء لنفسكَ وحيدًا، لكنّك لن تُصبح كذلك على الدّوام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن رواية ابن النّعمان بن بشير: أنه قال: (مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تدَاعى له سائر الجسدِ بالسَّهرِ والحُمَّى)، ومن ذلك نفهم قيمة النّاس للنّاس، وعلى سياق ذلك اتأمّل هبة الله لأجسادنا، الذي جعل العلامات الحيوية والاستطاعة الجسديّة تتعاضد مع الصّحة النفسية، وكيف يُعطي الإنسان العطف على نفسه حينَ يكون شاهدًا على ما يحدث داخل جسده وبين أجهزته وأعضائه، الآن أشعر بمُجاهدة جهازي التنفّسي للوباء الذي يخرج على هيئة ألم، وأُحاول ألّا تسقط عزيمة جسدي ولا حالتي النفسية المستقرّة، رُغم أن سائر جسدي تداعَى لهذه المناعة بالسَّهرِ والحُمَّى، ولكنها خفيفة، وأسعى إلى أن تبقى خفيفة.
لا زلنا في اليوم الأوّل، عند السّاعة الرابعة عصرًا، في غُرفةٍ واسعة أقضي فيها معظم وقتي، مُسلّحة بكل مسبّبات الأُلفة في العزل المنزلي، شاشة تلفاز كبيرة، ومكتبة صغيرة، وطاولة مليئة بكل الأدويةِ والمُسكّنات بجانب السّرير، علبة ماء كبيرة، الألوان والدّفاتر، بالإضافة إلى مرآة كبيرة اختلس النظر فيها بين الفينة والأخرى لأُحفِّز ذاتي، وخزانة ملابس أتأنَّقُ منها، وحُمرةٍ وكُحلة أتجمَّلُ بها حتى لا أستسلم، نعم هكذا تتحمَّل الأنثى آلامها الجسدية والنفسية والصحيّة، لذلك قويّات، هُناك أيضًا جلسة أرضيّة أهرب إليها مع ابريقٍ من الشّاي، قرأتُ رسائل الشُّعراء إلى حبيباتهم، والتّعريفات الشهيرة للحب، وتابعت الوثائقيات البسيطة عن المودّة بين الناس.
وفي اليوم الأوّل، تحمّلت الكثير من الألم لأبقى مستيقظة طوال النّهار، لأخذ كفايتي من الشّمس والنور، في اليوم الأوّل كرهت العتمة كثيرًا، وعندما أنهيتُ فروضي الشرعية وهاتفتُ والدتي، نمت!
(2)
السّبت، الساعة الواحدة ظهرًا، لا زلت على السّرير، مُستيقظة مذ العاشرة صباحًا، لكنني لم أقوى النهوض، صدح نداء الأذان، وجاءتني الطاقة الجسدية بعدما لبّيته، مررتُ بالمنزل كله، بغرفهِ وممرّاته، أغلقت جميع الإضاءات، وشرعت كل النوافذ، تحسّست الشّمس الباسمة على أركانه، صنعتُ قهوتي وكتبت ورقة لمشاعر اليوم، قفز إلى ذاكرتي نقاش كان قد دار بيني وبين صديقةٍ لي عن الاستقرار وحيدة بمنزلٍ صغير والخروج منه إلى العمل، وفي نهاية اليوم نعود إليه وننام بتعب، لوحدنا فقط، كنت أُمجِّد لها هذا النوع من الاستقرار، اليوم، وفي هذه الأثناء بالتحديد، أعيش شكل سيئ من أشكال الاستقرار التي كنتُ أُمجّدها، في منزلٍ صغير، أقطن وحيدة، بلا أي شخص، ولا أستطيع الخروج منه أبدًا لتداعيات العزل المنزلي، كالصّفعة: كيف لم أنتبه إلى هذا.
السّاعة الثانية ظهرًا، كتبتُ رسالة إلى أحدهم، وصفتُ فيها أحلامي والأُمنيات الكبيرة، لطالما أحببت كتابة الرسائل على الهدايا وفي داخل الكتب التي أُعيرها، كتبت رسائل الفرح، والحُب، والعتاب، والحُزن، داويتُ كل ما أشعر به عن طريق الكتابة على أوراقٍ صغيرة ومناديلٍ ضائعة، شعرتُ اليوم أنني بحاجة الكتابة بشكلٍ عاجل، وأعطيت كل شعورٍ زاحم قلبي حقّه من مفرداتي، لذلك كانت ظهرية حانية، والرّائع أن هناك هدنة مؤقتة أُقيمت بين أعراض الوباء وبين جسدي، مرحى!
السّاعة التاسعة ليلًا، بدأ الصّداع يدق أبواب رأسي، وآلام الجسد تسحبني للاستلقاء، وخضعت لذلك، لم يعد هُناك ما انتظره لليوم أو ما أُريد فعله، سأقرأ إلى أن أنام.
(3)
الأحد، السّاعة العاشرة صباحًا، لستُ مُتعبة، ولكنني لا أودّ النهوض من السّرير، حتّى أنني نهضت لأضع هاتفي على الشّاحن ومن ثمّ عُدتُ للسرير مباشرةً، أيضًا في البارحة لم أنام عند التاسعة، بل سهرتُ حتى الفجر، كنتُ طوال الليل أتبادل أطراف الحديث مع شخصٍ عزيز عبر الهاتف، بقيَ معي حتّى اطمأن أنني نمت، كنتُ قد قلتُ له أنني أخافُ الوحدة وأني مُتعبة من رأسي، وسهر معي لأكثرِ من خمس ساعات، همسنا لبعضينا الكثير من مُفردات الطمأنينة التي يُمكن للإنسان الشّعور بها من خلال إنسانٍ آخر.
عندما استيقظت لم يقفز لذاكرتي إلّا ما قُلناه في تلك المكالمة الطويلة، بقيت معزولة عن الدّنيا للحظات، قبل أن يعود ألم رأسي مجددًا، نهضت أجرّ معي طاقتي، وكعادتي؛ أنطلق للحياة بكوبِ قهوة.
السّاعة الثانية ظهرًا، نظرتُ نظرة سريعة لغُرفتي التي أقضي فيها كل فترة العزل بعد الإصابة، فكّرت: ماذا لو نقلتُ هذه الطاولة إلى هذه الجهة، وأزحتُ السرير إلى هذه الجهة؟ جاءتني رغبة مفرطة ومُلحّة بتغيير شكل المكان وتجديد هويّته قليلًا، وهذا بالفعل ما قمت به، فبعد أربع ساعاتٍ، خرجتُ من الغرفة وعدتُ إليها بطاقةٍ معنوية جديدة، كل شيء يحتفظ بروحهِ الجميلة التي أُحبّها، ولكن الذي تغيّر فقط المكان، أُحبُّ الشّمس كثيرًا، ولو بوسعي وضع كل شيء في الغرفة في وجهِ الشّمس لوضعته.
السّاعة الحادية عشر ليلًا، جئت للسّرير بعدما وضّبت المطبخ والخزائن، بدأ رأسي يؤلمني ويضيق التنفس لديّ، لا أُعاني من أي عارض صحّي مُصاحب للمرض باستثنائهما، ارتديت معطف أُحبّه من أحدهم، وأشعر في هذه اللحظة أن أثمن ما قد يضعه شخص عند أحبائه شيءٌ من ملابسه ورائحته عطره، ولذلك أُفضِّل الهدايا التي تكون قابلة للارتداء والاستخدام الطويل، بالإضافة إلى العطور والكتب.
الآن.. أظنني سأنام!
(4)
السّاعة الثامنة صباحًا، باكرًا كثيرًا بالنّسبةِ لفتاة تعتزل صحيًا ولا تمتلك أي نشاط من الأنشطة التي كانت تنهض لأجلها هذه السّاعة، لكن رأسي ثقيل، يؤلمني كثيرًا، وفي صدري دقّت أجراس الحرب، آلام الوباء بدأت تضغط عليّ، حتّى أنها تُفسد نومي! للحظات أشعر وكأن هناك من يُدخل سكاكينه داخل صدري ويُخرجها بكل قوّته، الماء يُخفِّف علي هذه المرحلة، الحمد لله أنّ هناك ماءً وأستطيع شربه.
كنتُ قد وضعت نظامًا في أول ساعة من اليوم واتبعته منذ فترةٍ طويلة، لا وسائل التواصل الاجتماعي، ولا رؤية الأخبار، لكنني اليوم شاهدتُ بثًا مباشرًا للأخبار عبر منصّة تويتر، ريان، الصبي المغربي الذي سقط في البئر وتوفيَ بعدما أسعفوه، كنت مستاءة من تعاطي بعض البشرية وكيف أصبحت مأساته وعائلته عرضة للاحتيال وتصفية الحسابات، وكيف تأذّت الجروح النيام وتراقص الإعلام وسكب الملح سكبًا انتهازًا للحادثة، حزنتُ لأجله بالتأكيد، ولكن كابرتُ ولم أفصح لأحد أنني أكره ما فعله النّاس تحت اسمه الطاهر، ولكنني سقطت بتغريدةٍ واحدة، بكيت! ولك أن تتخيّل أي سوء تقترفه بحق نفسك إن تعرّضت لهذا الجو وأنت للتو نهضت من نومك!
السّاعة العاشرة والربع صباحًا، أتأمّل قهوتي، وأُقلّب صفحات كتاب لا تقولي أنّكِ خائفة، توقّفت عن قراءته منذ وقت طويل حتى أنني نسيت عند أي صفحة سأستأنف القراءة، لدي صفوف دراسية إلكترونية بعد الظهر عزمت على حضورها، طالما كل الذي أحتاجه شاشة حاسوب فلما لا؟ بالواقع أحتاج فعلًا أن أسمع أصواتٍ مُختلفة، اشتقت لاعتزازي بنفسي عندما يفتقدني المحاضر بين الحضور ويطلب منّي التفاعل معه، لذلك سأحضر صفوفي الإلكترونية لهذا اليوم.
السّاعة الرابعة عصرًا، هاتفتني صديقة وشاركتني كل الذي واجهته في الجامعة، ردّدت أنها مشتاقة للقهوة التي نشربها سويًا أثناء ساعات الاستراحة، فرحت كثيرًا بهذه المكالمة، احتجت صدقًا أنّ أرى مكانتي الغائبة عند أحدٍ ما.
السّاعة التاسعة مساءً، بسط الليل برودته، استمعت لبعض الموسيقى والقصَائد بالفصحى، وتابعت مقطعًا مرئيًا عن ثقافة الاعتذار، أصبحت الآن ناضجة أكثر من السّابق بشأن الاعتذار، وأفهم كل الذين يُخطئون ولا يملكون شجاعة الاعتذار الصّريح، هُناك لغات كثيرة للاعتذار، هل تعلمون؟ هناك من يحتضنك عوضًا عن كلمة الأسف، هناك من سيشدّك إليه بفعله، سيصنع لك قهوتك أو يشتريها، سيجلب لك كأس ماء، سيشتري لك صنفًا تحبّه من مطعمك المُفضّل، وسيكتب لك الرسائل ويدسّها في جيبك أو حقيبتك أو داخل كتبك، أو يُثبّتها على الخزانة، وأحيانًا كثيرة يعتذر الشّخص في مكالمة صامتة، حدث سوء فهم بيني وبين إحداهنّ الغالية عندي، كتبت رسالة بخطِّ يدي وأرسلتها مع الورد إليها، الصّادم والمُحزن أنّها لم تُقدِّر ما وضعته من روحي في هذه الرسالة على شكل كلمات مُعتذرة ومُحبّة، ولا أُحب من لا يضع رسائلي في منزلتها المُستحقّة، لذا هذا الذي سأنام على حُزنه الليلة.
ننتظر اليوم الخامس من العزل!